الخميس، 31 يوليو 2014
الأربعاء، 30 يوليو 2014
"الكرة النطّاطة" قصة مترجمة للأطفال بقلم: نيتي لونشتاين
الكرة النطَّاطة
نيتي لونشتاين
اشترت
الطفلةُ «جنى» كرةً صفراءَ فأخذتها إلى البيت، وما لبثت أن راحت تلعبُ بها
بأن تقذفها إلى الحائِط وتلقفها.. وهكذا، وما إن ألقت بها إلى الأرض حتى ارتدت إلى
أعلى لترتطم بالسقف ثم ترتد لتصطدم بالقطة، ثم انفلتت بعد ذلك من الباب الذي كان
مفتوحًا إلى الخارج.
تابعت جنى
«الكرةَ» إذْ جرت إلى الطريق بعينيها، لكنها كانت قد اختفت تمامًا، فلم تعثر
لها على أثرٍ في أي مكان.
كان بائعُ
اللبن في الجانب الآخر من الطريق قد غادر شاحنته فوجدَ الكرةَ التي أعطاها
لابنه الصغيرِ، وهو يقول له: لقد وجدتها في شاحنتي.
سأله ابنه:
كيف دخلت الكرة الشاحنة؟
قال الأب:
لا أعرف.
شكر الابنُ،
الذي بدا سعيدًا أباه، ثم راح يلعبُ بالكرة، يقذفها مرة إلى أعلى فتصطدم
بالسقف، ومرة أفقياً لترتد من الحائط، وهكذا، وبينما هو كذلك إذْ بها تنفلت إلى
الطريق وتظل تتدحرجُ إلى أن تنفلت إلى الحديقة وتجتاز سورها.
تَصَادَفَ
أثناء ذلك مرورُ باص، كانت تركبه الطفلةُ «رنا»، مع أمها، وبينما هما جالستان في
مكانهما إذْ بالطفلة «رنا» تصيحُ فرحةً: انظري يا أمي.. إنها كرة.. لقد دخلت من
النافذة.
وما إنْ
حاولت اللعب بها حتى انفلتت من النافذة إلى خارج الباص، لتستقر َبين أَقفاصِ الجزر
والبصلِ والبندورة والتفاح والإجاص، التي كانت تنقلها إحدى الشاحناتِ التي تَصَادَفَ
مروُرها آنذاك بجوار الباص، ولما وقفت الشاحنةُ وراء إشارة المرور الحمراء تدحرجت
الكرةُ وَسقطت إلى الطريق، وظلت تثب مرةً واثنتين وثلاثًا لتعبر أحد الجسور.
انظر إلى
هذه الكرة.. صاح «رامي»، لقد سقطت من فوق الجسر، ثم أخذها ليلعب بها هو واخوه
الصغيرُ، إذْ راحا يتقاذفانها بينهما، لتنفلت منهما فجأة وتتدحرج نحو الطريق،
ثم إلى أرض خلاء واسعة مسيجة بسورٍ، وهكذا حتى تدحرجت إلى الطريق، لتصيح «جنى»
فرحة: ها هي كرتي التي كنت قد فقدتها تعود إليّ. وراحت تلعب بها في حرصٍ شديدٍ
حتى لا تفقدها مرةً ثانيةً، وهي فرحةٌ سعيدةٌ.
الثلاثاء، 29 يوليو 2014
قصة لأطفال فلسطين بقلم: عمار علي حسن
قصة لأطفال فلسطين
عمار علي حسن
«هذه قصة للأطفال كتبتها عام 2001 من وحى انتفاضة الأقصى، ونالت جائزة هزاع بن زايد الإماراتية لأدب الأطفال، لكنها لم تُنشر من قبل، وظلت حبيسة الأدراج ثلاثة عشر عاماً، وأجدها الآن مناسبة كى أهديها إلى أطفال فلسطين، الذين قتلتهم طائرة إسرائيلية بلا رحمة وهم يلعبون على شاطئ غزة فى براءة، غير عابئين بحسابات قساة القلوب ومظلمى العقول من دهاقنة السياسة وتجار الدم».
■■■
دخل المعلم إلى الصف ووجهه مملوء بالثقة، وعيناه تفيضان بالحماس. نظر إلى تلاميذه وقال: ها قد عدنا يا صغارى الأعزاء إلى مدرستنا الجميلة بعد شهر ونصف شهر من الغياب الإجبارى.
أرسل عينيه هناك حيث البيوت المهدمة، والأشجار التى اجتُثت وألقيت تحت أكوام التراب، ثم فتح حقيبته، وأخرج منها علبة خضراء اللون، رفعها بيده اليمنى وقال:
- هذه جائزة سأمنحها لمن يحكى لنا أفضل تجربة له فى مقاومة الاحتلال، سينالها أكثركم دفاعاً عن أرضه وأهله وعرضه.
وعاد المعلم يتطلع فى وجوه تلاميذه مرة أخرى وسألهم:
- من منكم لديه تجربة يقصها على أسماعنا؟
فرفع جميع التلاميذ أيديهم.
وهنا قال المعلم:
- إذن سنختار ثلاثة منكم عن طريق القرعة، ليحكوا لنا تجاربهم.
ووزع على التلاميذ أوراقاً صغيرة، وطلب من كل واحد منهم أن يكتب اسمه فى إحداها ويطويها، ثم جمع الأوراق المطوية، ووضعها فوق إحدى الطاولات، وطلب من أحد التلاميذ أن يأتى ويسحب ثلاثاً منها بطريقة عشوائية.
وبعد إجراء عملية السحب، أصبح على كل من زياد وعمرو وإياد أن يحكوا للجميع تجاربهم مع جنود الاحتلال.
وسأل المدرس تلاميذه:
- بمن نبدأ؟
فرد زياد وقال:
- نبدأ حسب ترتيب الحروف الأبجدية لأسمائنا.
وأصبح على إياد أن يبدأ..
■ ■ ■
وقف فى منتصف الصف، وقال والعيون تتابعه بلهفة:
«حين دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلى مدينتنا وسدت منافذ الشوارع الرئيسية كان أخى الأكبر محمود يعانى من نوبة ضيق التنفس الحاد التى تأتيه من حين إلى آخر. لكن حقن «الإيتافيللين»، التى يتعاطاها من أجل أن تزول هذه النوبة، كانت قد نفدت. كان علىّ أن أفعل شيئاً وأنا أسمع صراخ جدتى العجوز، التى بقينا معها بعد استشهاد أبى وأمى منذ خمس سنوات على أيدى الإسرائيليين عند أحد المعابر.
كانت أمى مريضة ومنعها الجنود من الوصول إلى المستشفى، وحاول أبى أن يقنع الجنود بألا يحتجزوهما طويلاً لأن حالتها خطيرة، لكن أحداً لم يستجب إلى توسلاته، فما كان من أبى إلا أن انقضّ على جندى منهم ضرباً وركلاً بعد أن فقد أعصابه، فأطلق الجنود النار عليه وعلى أمى.
كان علىّ أن أحاول إنقاذ حياة أخى وتهدئة خواطر جدتى المسكينة. نظرت من النافذة فوجدت أمام البيت دبابة وثلاثة جنود مسلحين بالرشاشات الآلية الخفيفة. رأيتهم يطاردون صبياً مقبلاً يحمل أرغفة أحضرها من عند أحد أقربائه لأهله المحاصَرين الذين لا يجدون شيئاً يأكلونه. أطلقوا الرصاص عليه ففر هارباً، وسقطت الأرغفة من يده، فراحوا يدوسونها بأحذيتهم الثقيلة. وحينها أدركت أننى لو هبطت إلى الشارع بحثاً عن صيدلية سيكون مصيرى مثل مصير الصبى. لكن اشتداد المرض على أخى ونحيب جدتى جعلنى أصمم على النزول لأحضر لأخى الدواء مهما كان الثمن.
جريت إلى غرفة نومنا الوحيدة. فتحت النافذة التى تطل على حارة ضيقة كانت خالية من الجنود والدبابات، فهى لا تتسع حتى لدبابة واحدة. أمسكت بماسورة الصرف الصحى المجاورة للنافذة، وهبطت عليها حتى وجدت قدمى راسخة على أرض الحارة. ورحت أجرى ناحية الشارع الخلفى الذى تقع فى منتصفه صيدلية صغيرة.
وما إن خرجت من ضيق الحارة حتى لمحت جنوداً كثيرين ودبابات وعربات مصفحة تقف هناك فى منتصف الشارع أمام باب الصيدلية المغلق. وقفت حائراً أقول لنفسى:
رجوعى بلا دواء يعنى الموت المحقق لأخى.
كانت الشمس قد غربت والليل راح يفرش رداءه الأسود على البيوت بعد أن قطع الجنود الإسرائيليون التيار الكهربائى، وأغرقوا المدينة كلها فى ظلام دامس. تذكرت أن أحد الصبية من أصدقاء أخى يعانى من نفس المرض الذى يصيب أخى، وجاءته النوبة يوماً وهو فى بيتنا، فجرى أخى إلى صيدلية الإسعافات الأولية الصغيرة المثبتة فى أحد حوائط صالة بيتنا، فتحها وأخرج منها علبة الحقن وإحدى السرنجات، ثم حقنه بالوريد فارتد إليه الوعى بعد أن كاد يدخل فى غيبوبة.
كان منزلهم فى هذا الشارع المملوء بالجنود، فانبطحت على الرصيف، ورحت أزحف ملتصقاً بالحائط، كى لا يرانى أحد منهم حتى وصلت إلى باب بيت صديق أخى. طرقته بهدوء، وسمعت صوتاً من الداخل يسأل:
من؟
فقلت وأنا ألهث:
أنا إياد.
فتحوا الباب لى. كنت متعباً وملابسى ملطخة بتراب الشارع وأوحاله، لكننى كنت سعيداً لأننى وصلت إلى المكان الذى سأجد فيه شفاء أخى العليل. طلبت الدواء منهم فأعطوه لى. وعلمنى صديق أخى فى دقائق معدودات كيف أجهز الحقنة، وكيف أغرسها بلطف فى الوريد أو فى العضل حتى تعود الحياة إلى أخى بعد أن بقى طويلاً على حافة الموت.
وخرجت من عندهم، وزحفت عائداً إلى الحارة الضيقة التى تمتد خلف بيتنا حتى وصلت إليها فرحت أنفض ملابسى وأنا أجرى مسرعاً حتى صرت واقفاً تحت نافذة شقتناً الكائنة فى الدور الثانى.
ناديت جدتى بصوت خفيض، وطلبت منها أن تلقى إلىّ بحبل الكتان الذى اشتراه أخى، ليصنع به مقلاعاً نقذف به الأحجار على جنود الاحتلال.
رمت جدتى إلىّ بالحبل، فربطته بإحكام حول جذعى، وطلبت منها أن تربط طرفه الآخر فى السيخ الحديدى الذى يثبت ماسورة الصرف الصحى فى الحائط، وتسلقت صاعداً حتى وصلت إلى النافذة، وقفزت داخل غرفة نومنا.
كان أخى قد أشرف على الموت، فعاجلته بحقنة فى الوريد، فأخذ يتعافى شيئاً فشيئاً حتى عادت إليه الحياة».
كان التلاميذ يتابعون إياد فى صمت وإعجاب، وحين انتهى من حكايته انطلقوا فى تصفيق حار له. وقال له المدرس:
حقاً إنك بطل مغامر.
فتمتم إياد إليه بامتنان، ثم قال وهو ينظر إلى أستاذه وزملائه:
أشكركم جميعاً، فما فعلته يُعد قليلاً بالنسبة لما قام به أطفال وصبية آخرون.
■ ■ ■
وجاء الدور على زياد ليروى حكايته.
تقدم هو الآخر إلى منتصف الصف، ونظر إلى التلاميذ الذين استعدوا للإصغاء وقال:
«كانت ليلة عصيبة. أنا وأمى وأبى كنا نتحلق حول طاولة الطعام فى مطبخ بيتنا، نتناول عشاءنا بعد يوم ملىء بالتعب. لم يكن لدينا من طعام سوى أرغفة جافة قليلة، وجبن وبضع حبات من الطماطم. فالحصار الذى ضربه جنود الاحتلال الإسرائيلى على مدينتنا، ووجودهم الكثيف فى الشوارع منعنا من التزوّد باحتياجاتنا من الطعام.
لم نكن قد أكلنا سوى لُقيمات قليلة حتى سمعنا صوت انفجار كاسح دوى فى آذاننا وشعرنا على الفور بزلزال رهيب يرج حوائط البيت رجاً، فراحت تترنح وسط الغبار الخانق. هممنا لنجرى أنا وأمى، لكن أبى صاح فينا:
- امكثوا تحت المنضدة حتى لا تصابوا بسوء.
ودفعنا أجسادنا تحت المنضدة ونحن نرى الحوائط تتكوم فوقنا بعد أن تقذفها دانات الدبابات الواقفة إلى جانب البيت، حتى أحاط بنا ظلام تام. حاول أبى أن يعتدل فى جلسته حتى يريح جسده المنهك، لكنه وجد أن رجله اليمنى قد انحشرت بين قطعتين كبيرتين من الخرسان المسلح. أما أمى فقد شعرت من شدة الخوف أنها تكاد تفقد جنينها، ابن الأشهر الثمانية، فراحت تصرخ:
- أنقذونا.. أنقذونا.
وأخذ أبى يهدئ من روعها قائلاً:
- لا تخافى شيئاً، سنخرج بإذن الله سالمين.
ومرت ساعات، لم نكف فيها عن الكلام، حتى نؤكد لأنفسنا أننا لا نزال أحياء.
وفجأة رأينا خيطاً رفيعاً من النور يتسرّب إلى البقعة الصغيرة التى تضمنا تحت الحوائط المنهارة. قلت متهللاً:
- انظر يا أبى، إنها شمس الصباح.
فرد قائلاً وهو يشير إلى النور:
- هذه الفتحة ستكون لنا مخرجاً بإذن الله.
ولأننى كنت الأقرب إليها، فطلب أبى منى أن أضع فمى على فوهة الفتحة وأنادى بأعلى صوتى على العابرين، لعل واحداً منهم يسمعنى ويأتى لينقذنا.
ورحت أصرخ:
- أنقذونا.. أنقذونا. نحن هنا تحت الحوائط المنهارة.
لكن أحداً لم يسمع. ورأيت شيئاً يلمع فى النور فمددت يدى إليه، فوجدته سكين المطبخ. غمرتنى الفرحة، وقلت لأبى:
- وجدت السكين.
فسألنى بصوت مجهد:
- ماذا ستفعل به؟
فقلت له:
- سأحاول أن أوسع هذه الفتحة الضيقة حتى يمكننى الخروج منها.
فصمت أبى برهة، وقال:
- أخشى أن تنهار علينا الحوائط تماماً، أو يثير حفرك الأتربة فتخنقنا.
فقلت له:
- لا تخشَ يا أبى، سأكون حذراً.
ودفعت بالسكين إلى الفتحة الضيقة، وأخذت أحفر فى دأب شديد لساعات طويلة حتى وسعت الفتحة على قدر جسدى، وزحفت إلى أعلى بين قوالب الطوب الأحمر حتى أطلت رأسى على الخلاء. كانت الشمس توشك أن تغيب، وجنود الاحتلال قد رحلوا بعد أن دمروا بيوتاً عديدة، وتركوا وراءهم عشرات الشهداء.
جريت أبحث عن أحد، لكن جيراننا كانوا قد رحلوا، أو دفنوا تحت أنقاض البيوت المتهدمة.
لم أجد سوى الحاج خليل صاحب محل البقالة يجمع ما تبقى من بضائعه القليلة التى نهبها الجنود. قلت له وأنا ألهث:
- أمى وأبى محجوزان تحت ركام بيتنا الذى هدمته دبابات العدو.
وترك الحاج خليل ما بيده من بضائع، وراح يجرى معى حتى وصلنا إلى الفتحة الضيقة. كان الظلام قد حلّ تماماً فلم يرَ الحاج خليل شيئاً بداخلها، لكنه سمع صوت أبى ينساب من تحت الحوائط بآيات من القرآن الكريم.
نظر إلىّ وقال:
- لا بد أن عمال البلدية قادمون ليبحثوا عن أحياء تحت الأنقاض.
فقلت له:
- لكننى لا أستطيع الانتظار حتى يأتوا.
وضع الرجل يده على كتفى ليهدئ من روعى، وقال:
- انتظر بجوار والديك، وأنا سأذهب لأستعجل عمال البلدية.
مكثت بجانب الفوهة التى يأتى منها صوت أبى العذب، وهو يقرأ آيات من كتاب الله لكى يطمئن قلبه. وكنت أنا أطمئنه هو وأمى بأنهما سيخرجان بعد قليل. ومرت الدقائق علىّ كأنها سنوات كاملة. وسمعت صوت هدير يأتى من بعيد، فنظرت فإذا بالجرافة قادمة، والحاج خليل يسبقها وهو يشير بيده ناحية منزلنا المتهدم.
وما إن وصلت الجرافة حتى راحت ترفع الأنقاض. وبعد أكثر من ساعة من الحفر خرجت أمى وأبى إلى الحياة».
هز المعلم رأسه، وابتسم لزياد، وقال له:
- إنك ابن بار بوالديك.
وانطلق التلاميذ يصفقون له بشدة، وهو يبتسم ويحييهم، ثم قال وهو يسير باتجاه السبورة ليقف بجوار صديقه إياد:
- كلما تذكرت أن والدىّ كان من الممكن أن يموتا تحت الأنقاض أرتجف، وتملأنى كراهية لهؤلاء الذين يريدون قتلنا جميعاً.
■ ■ ■
وجاء الدور على عمرو.
تقدم إلى منتصف الصف، ثم نظر إلى وجوه زملائه، وراح يحكى قصته مع جنود الاحتلال قائلاً:
«حين داهمت دبابات العدو مدينتنا كنت عائداً من المكتبة العامة، التى طلبت من أبى أن يدفع لى رسوم الاشتراك بها حتى أتمكن من استعارة الكتب والقصص وأقرأها فى إجازة نهاية الأسبوع.
كنت أسير على رصيف الشارع، وفجأة وجدت عدة جنود تتقدمهم دبابة يطلقون الرصاص فى اتجاه المارة فيجبرونهم على الفرار إلى بيوتهم. التصقت بمدخل إحدى البنايات لأرى ما سيحدث، بعد دقائق معدودات أمسك أحدهم بمكبر الصوت، وأخذ ينادى على شاب أعرفه جيداً. إنه محمود أبوحسين، الذى طالما اشترى لى الحلوى وأنا صغير، ولعب معى، وهو الذى علمنى الحروف الأبجدية وجدول الضرب وحبب إلى نفسى وعقلى قراءة الكتب الثقافية والعلمية، وظل يساعدنى فى استذكار دروسى حتى أصبحت فى الصف الأول الإعدادى كما ترون.
بعد دقائق خرج رافعاً ذراعيه إلى أعلى، وعرفت فيما بعد منه أنه لم يكن معه سلاح لكى يقاوم الجنود. وحتى لو كان معه سلاح فهو يخاف أن يجلب الهلع وربما الموت لنساء البيت. أمسكه الجندى من كتفه، وهزه بعنف شديد، ومحمود ينظر إلى عينى الجندى فى تحد وكبرياء.
وضع جندى بندقيته فى رأس محمود، وراح آخر يربط يديه من الخلف بشريط بلاستيكى أبيض، وتحرك بقية الجنود إلى الشارع الجانبى بحثاً عن فدائيين آخرين، وتركوا جندياً واحداً بجوار محمود يحرسه حتى تأتى العربة فيقذفونه داخلها مع رفاقه ليحتجزوهم هناك فى معسكر أقاموه خارج المدينة.
وكنت قد شاهدت بالأمس فى التليفزيون كيف كان الجنود يقتلون بعضاً ممن يعتقلونهم، فشعرت بخوف شديد على محمود، ووجدت أن من واجبى أن أفعل شيئاً من أجله.
استعدت اللحظات الماضية حين كنت أشارك أطفال الحى فى قذف الجنود الإسرائيليين بالحجارة. كنت ممن يمسكون بالقادوم ليصنعوا أسناناً مدببة للأحجار الصغيرة، ويهشمون الأحجار الكبيرة إلى قطع يستطيع الصغار أن يقذفوها إلى أبعد مسافات ممكنة.
نظرت حولى فلم أجد حجراً واحداً، لكن عينى لمحت بلاطة غير مثبتة جيداً فى مكانها بمدخل البناية. أمسكتها بيدى، وضربتها على أولى درجات السلم بحذر شديد حتى لا يسمع الجندى صوت ارتطامها بالحجر فيعرف مكانى. شطرتها إلى نصفين، ونظرت إلى حيث يقف الجندى فوجدته قد أمر محمود بأن يولى وجهه إلى الحائط ويقف مستسلماً. أما هو فقد تراخى مع مرور الوقت، بعد أن اطمأن إلى أن أسيره لن يستطيع الفرار أبداً.
وشعر الجندى بالضيق من الخوذة الحديدية التى تغطى رأسه، فأزاحها إلى الخلف على عنقه، وأخذ يدلك جبهته بيده التى كان العرق يتصبب منها، ويده الأخرى تقبض على بندقيته من ماسورتها الأمامية.
وجدت أنها اللحظة المناسبة للانقضاض عليه. خرجت من مخبأى ورحت أسير على أطراف أصابع قدمى حتى لا يشعر بى، ونصف البلاطة المسنونة فى يمينى حتى صارت بينى وبينه ثلاثة أمتار فقط. وبكل ما أوتيت من قوة قذفت الحجر إلى جبهته فخر ساقطاً، فاقد الوعى، والدم يسيل على وجهه.
والتفت محمود بسرعة ليرى ما حدث حين سمع صرخة الجندى الجريح، فوجدنى أمامه.
قال وهو يتهلل فرحا:
ـ أنت بطل يا عمرو.
وجريت إليه، وأمسكت بيديه أحاول أن أفك قيده، لكنه كان قوياً ومحكماً وعصياً على التمزق. حاولت أن أقطعه بأسنانى، لكن دون جدوى. كان علينا أن نتصرف بسرعة قبل أن يعود الجنود فيجدون زميلهم على حالته هذه فيقتلوننا فى الحال. ولم يكن أمامنا حل سوى أن يجرى محمود على قدر ما يستطيع وأن أجرى خلفه ماسكاً يديه المربوطتين اللتين تعيقان سرعته.
عدنا إلى بيت محمود وتمكن أهله أن يفكوا قيده باستخدام المقص وسكين المطبخ والنار، وقفز من السطح الخلفى للبناية إلى بناية مجاورة، وهرب للانضمام إلى شباب المقاومة، الذين كنا نسمع صوت رصاص بنادقهم، وهم ملتحمون مع جنود الاحتلال فى معركة حامية تجرى على أرض أحد الشوارع البعيدة».
■ ■ ■
حين انتهى عمرو من حكايته كانت عيناه مملوءتان بالدموع، نظر إلى زملائه وقال:
- لم أكن أتصور أبداً أن يقتل الجنود «محمود».
ورد المعلم:
- لا يُقتل محمود وهناك أمثالك.
ثم ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة وقال لعمرو:
- نعم التلميذ الوفى أنت.
ونظر المدرس إلى تلاميذه الصف جميعا وسألهم:
- ترى من يستحق الجائزة.
«الشجاع المغامر» أم «الابن البار» أم «التلميذ الوفى».
رد أحد التلاميذ الجالسين فى الصف الأمامى:
- كلها صفات حميدة.
وقال تلميذ آخر:
- هذه صفات نحتاجها جميعاً فى كفاحنا ضد العدو الذى يغتصب أرضنا ويخنق حريتنا.
ابتسم المعلم قائلاً:
- نعم كلها صفات حميدة.. لكن لا بد أن تختاروا واحداً من الثلاثة ليربح الجائزة.
وسادت لحظة صمت قطعها أحد التلاميذ قائلاً:
- أرى أن تقسم الجائزة بين الثلاثة.
ونظر المعلم إلى تلاميذه ليستطلع رأيهم فيما قاله زميلهم، فجاء ردهم بالموافقة حين انطلقوا جميعاً فى تصفيق حار.
■ ■ ■
وفتح المعلم العلبة التى تحتوى الجائزة، وأخرج مظروفاً أبيض يحوى مبلغاً من المال، وقال للتلاميذ الثلاثة:
- تعالوا لتتسلموا الجائزة.
وتقدموا إليه وسط تصفيق من زملائهم. ولما تسلموا جوائزهم لم ينصرفوا إلى مقاعدهم، بل وقفوا فى أماكنهم يتحدثون معاً.
ثم رفع «إياد» يده وقال للمعلم:
- أنا سأشترى بجائزتى سارية بدلاً من التى حطمها جنود الاحتلال وسننصب فوقها علم بلادنا فيرفرف فى فناء مدرستنا الحبيبة.
وقال «زياد» وهو يشير بيده ناحية سور المدرسة المتهدم:
- سأشترى فأساً وبذور ورد نزرعها فتزين مدرستنا، بعد أن داست أحذية الجنود الورود الجميلة التى كنا قد زرعناها فى بداية العام الدراسى فأفسدتها.
أما «عمرو» فقال:
- ستساعدنى قيمة الجائرة فى أن أحقق حلمى بتأسيس موقع لمدرستنا على شبكة «الإنترنت» نبث فيه كل حكاياتنا العصيبة مع جنود الاحتلال.
نقلا عن جريدة الوطن المصرية
"مَعْملي الصغِير" قصيدة للأطفال بقلم: نشأت المصري
مَعْملي الصغِير
نشأت المصري|
يا
معملي ما أََبْدَعكْ
|
أَحَبُّ
أوقاتــي مـعكْ
|
|
العلم
فيك عــيدُه
|
خاب
الذي قد وَدَّعَـك
|
|
**
|
|
|
والسحرُ
فيك والعَجَـب
|
صار
الـترابُ كالذهبْ
|
|
تجيب
عن سُــؤالـِنا
|
تحكي
لـنا عن الـسبب
|
|
لكل
لـونٍ قصــة
|
لون أتي ، لون ذهـب
|
|
حــديقة
الالـوان أنــــــــتَ فيـك كـل مـا نــحب
|
|
|
تـُلاَعِــب
الميــاهُ غيــرَهــا تــفور فــي غضــب
|
|
|
تـُشـَاكــس
الأشــياء بــعضها فــمن تـُري كَــسَب؟
|
|
|
هـــنا
صنــــاعةُ الحــديد من نِشارة الخـــــشب
هنا
صناعة الأخـشاب مــن مُــــصاصةِ الـــقَـصَب
**
|
|
|
وتكشـفُ
الـجيــناتُ ِسـرَّهـا مـضـى وقـت
الـتعـب
|
|
|
َيفْنى
هـــنا عَدُّونـا
|
َفنَسْتَرِد
ما اغْتَصب
|
|
َحـــْمدا
له إلــهَنا
|
لما
هَدَى وما وَهَب
|
|
**
|
|
|
يا
معملي ما أبدعـك
|
أَحَب
أوقَاتي مـعك
|
|
هذا
صديقي . َمرْحَبـاً
|
سعي
معي وَوَسَّعَك
|
الاثنين، 28 يوليو 2014
"رسم" قصيدة للأطفال بقلم: جليل خزعل
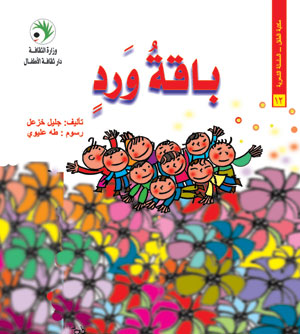
رسم
جليل خزعل
أكرهُ رسمَ الدبّاباتْ
أكرهُ رسمَ الطيـــّاراتْ
فهي تذكرُني بالــــحربِ
بالخوفِ وأجواءِ الرُعبِ
فأنا أبداً لا أتمنى
أن أرسمَ تلكَ الأشياء
يعجبني رسمُ الأنهارْ
وحقول فيها أزهـــارْ
لأحسَّ بأنّي إنسانْ
يحيا بسرور وأمانْ
الجمعة، 25 يوليو 2014
" البطة الصغيرة" قصة للأطفال بقلم: طلال حسن
البطة الصغيرة
طلال حسن
فوق السهول والتلال والأنهار ، حلقت البطة
الصغيرة إلى جانب أمها ، وهي فرحة بالحياة . وطوال ساعات وساعات ظلت البطتان
تحلقان ، وكانت البطة الصغيرة تتقدم أمها أحياناً ، وتصيح بجذل ..
ـ ماما .. لقد سبقتك .
أحست البطة الأم
بالتعب ، فصاحت بصوت لاهث ، وهي تراقب ابنتها .. البطة الصغيرة .. وهي تطير أمامها
بخفة ورشاقة :
ـ بنيتي ..
فأجابت البطة الصغيرة
: نعم .. ماما ..
ـ ألم تتعبي ؟
فصفقت البطة الصغيرة
بجناحيها .. وقالت بدلال :
ـكلا ..
قالت الأم في وهن :
ـ أنظري .. هناك بيارة جميلة ..
قالت البطة الصغيرة ،
وهي تطير فرحاً ..
ـ البيارات هنا في كلّ مكان ..
ـ ولكن ليست كهذه ..
ـ كلّ البيارات متشابهة ..
ـ ألا تحبين أشجار البرتقال ؟
ـ نعم ..
ـ هيا نراها إذن ..
ـ ليس الآن ..
ولكن .. يجب أن
ترتاحي .. يا بنيتي ..
ـ أنا لم أتعب بعد .. يمكنني أن أطير حتى المساء
.
فغمغمت الأم وهي تلهث
:
ـ آه منك
التفتت البطة الصغيرة
، وابتسمت لأمها ، وقالت بخبث :
ـ ماما ..
ـ نعم ..
ـ لماذا لا تقولي إنني تعبت .
ابتسمت الأم بحنان ،
وقالت :
ـ آه يا ملعونة ..
فقهقهت البطة الصغيرة
بفرح ، وقالت :
ـ هيا نرتاح إذن .
× ×
×
اتجهت البطتان نحو
البيارة ، لكنهما فوجئتا بأصوات اطلاقات وصراخ يصمّ الآذان ، وبين أشجار البرتقال
، رأت البطة الصغيرة ، جماعة من الرجال ، يهاجمون معسكراً للجنود ، فصاحت وهي
ترتعش من الخوف :
ـ ماما .
ـ لا تخافي ..
ـ ماذا يجري ؟
ـ لعلها .. حرب ..
ـ حرب !
ـ ربما ..
ـ ما معنى .. حرب ؟
ـ إنسان يقتل إنساناً ..
فصاحت البطة الصغيرة
بصوت مرتعش ..
ـ ولكن هذا جنون ..
ـ أجل .. ولكن يا بنيتي هناك حرب عادلة ..
ـ ماما .. لا تقولي لي .. إن القتل عادل ..
ـ ليس كلّ قتل ..
ـ إذا قتلتُ أختي ..
فهل هذا عدل ؟
ـ كلا ..
ـ إذن كيف يكون القتل عدلاً ؟
ـ لا تنفعلي .. دعيني أسألك .. وأجيبيني بهدوء
ـ حسن ..
ـ إذا حاول غراب احتلال عشنا وطردنا منه ، فهل
هذا عدل ؟
ـ كلا ..
ـ ماذا علينا أن نفعل ؟
ـ نمنعه ..
ـ وإذا لم يمتنع ؟
ـ ماذا !
ـ وقتل أباك وإخوتك ..
فصاحت البطة الصغيرة
بغضب ..
ـ نقاتله ..
ـ أرأيت .. هناك حرب عادلة إذن ، أنظري إلى
هؤلاء أ إنهم فلسطينيون ، وهم يقاتلون دفاعاً عن بيتهم ، إن حربهم عادلة ، أما
هؤلاء الجنود ، فإنهم صهاينة احتلوا بيت الفلسطينيين ، وطردوهم منه ، إن حربهم غير
عادلة .
صمتت البطة الصغيرة ،
وراحت تنظر إلى البيارة بأسى، فقالت لها أمها :
ـ والآن .. أنت مع منن ؟
فقالت البطة الصغيرة
بحزم :
ـ إنني أكره الغربان ..
فابتسمت الأم بحنان ،
وقالت لابنتها الصغيرة :
ـ الفلسطينيون يكرهون الغربان أيضاً ، إنهم
يكرهون الحرب ، لأنها دمار ، لكنهم يكرهون الغربان أيضاً .. ولهذا فإنهم يقاتلون .
× ×
×
حلقت البطة الصغيرة
مع أمها بعيداً ، وهي تنظر إلى
الأعداء بغضب وازدراء
.
الخميس، 24 يوليو 2014
"تحية المسجد" نص للأطفال بقلم: محمود سلامة الهايشة
تحية المسجد
محمود سلامة الهايشة
توضأ واصطحب ولده إلى صلاة الفجر، وعندما دخل المسجد، استقبل
القِبلة وهمَّ بأداء ركعتي تحية المسجد، أما ابنه فهمَّ بالجلوس بجواره، فنظر إليه
وأشار بيده هامسًا: قم وصلِّ ركعتي تحية المسجد، فقام الولد على مضض وصلَّى، وبين
الأذان والإقامة اقترب الأب من أذن ابنه وقال:
♦ ذكِّرني عندما نخرج من المسجد
أحكي لك قصة.
فهزَّ رأسه مُعلنًا الموافقة.
مرَّت الدقائق، وأقيمت الصلاة، عندما خرَجوا نظر الولد إلى أبيه بلهفة:
♦ هيا احكِ لي القصة التي وعدتني
بها.
♦ آه.. جميل أنك ما زالت متذكرًا،
الموضوع بخصوص ركعتي تحية المسجد، عندما كنا صغارًا في مثل سنك الآن....
♦ "من أنتم يا أبي؟".
♦ أنا وأصدقائي الأطفال في
الحيِّ، عندما كنا ندخل المسجد لم نكن نهتمُّ بصلاة ركعتي تحية المسجد، وفي إحدى
المرات ناداني الحاج عوض - رحمه الله - أحد رجال المسجد الكبار، وكان صاحب أقدم
محلِّ بقالة في المنطقة، فذهبت إليه مسرعًا؛ حيث كان يجلس مُسنِدًا ظهره إلى
المنبر، فعندما اقتربت منه، قال لي: يا بني، لمَ لا تُصلي ركعتي تحية المسجد أول
ما أتيت أنت وزملاؤك؟!
فسكتُّ وتغيَّر وجهي ولم أستطع الرد عليه!
فأحسَّ أنه قد أحرجَني جدًّا، وبأسلوب جميل وبابتسامة أجمل:
يا بني، هل عندما تدخل بيتًا من البيوت.. هل تدخل وتجلس وتتكلم وتفعل ما تشاء دون
أن تُسلّم على أهله؟!
- بكل تأكيد لا؛ فقد أمرنا الله
في قوله الكريم في سورة النور: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النور:
27].
فابتسم الحاج عوض، ما شاء الله عليك، ممتاز أنك تحفظ هذه
الآية الكريمة، طالما أنت تعرف ذلك، فلماذا لم تسلِّم على صاحب هذا البيت؟!
فتلفتُّ يمينًا ويسارًا، متعجبًا أيَّ بيت يقصد، ثم نظرت في وجهه!
♦ نعم، هذا المكان، المسجد، هو
بيت الله؛ حيث قال سبحانه في سورة الجن: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ
فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: 18].
♦ وكيف أسلِّم على صاحب البيت؟!
♦ بصلاة ركعتي تحية المسجد.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)









